omouloud omar
عضو متألق
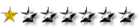
عدد المساهمات : 27
نقاط : 5512
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
 |  موضوع: مشكلات الفلسفة في المجتع الإسلامي موضوع: مشكلات الفلسفة في المجتع الإسلامي  الأربعاء يناير 13, 2010 8:56 pm الأربعاء يناير 13, 2010 8:56 pm | |
| مُشكِلة الحُريّة بَين المذاهبْ الفلسفية والموقف الإسلامي
مشكلة حرية الإنسان، من أهم المشكلات التي عالجها علماء الفلسفة والأخلاق، قديماً وحديثاً. ولا ريب أن من أهم العوامل التي أضفت الأهمية على هذه المسألة، شدة صلتها بحياة الإنسان الفردية والاجتماعية.
كما أن مسألة الحرية هذه، بقيت، على الرغم من شدة اهتمام الفلاسفة بها، وكثرة معالجتهم لها، أكبر معضلة تأبت على كل الحلول والاقتراحات التي تطارحها الفلاسفة، في مختلف عصورهم، وعلى تنوع مذاهبهم واتجاهاتهم!.
لقد بقيت آراؤهم واقتراحاتهم بصددها معزولة ومحصورة على صعيد الأقوال وفي بطون الكتب، وظل واقع المجتمعات الإنسانية بعيداً عنها، غير عابئ بها، حيث سارت الحرية الإنسانية متلونة ومتأثرة بأسباب وعوامل أخرى، كانت في كثير من الأحيان عوامل عشوائية كيفية، لم تنسقها أي إرادة واعية طبق منهج أو قرار مدروس.
ولست الآن بصدد عرض مذاهب الفلاسفة وصراعاتهم، حول تحديد معنى الحرية الإنسانية وعلاقتها بالسلوك الإنساني، وبيان مواقفهم المضطربة من نقيضها الذي ما زال يتربص بجوهرها، وينتقص من أطرافها وهو الذي يسمونه الضرورة أو الحتمية، بكلا قسميها: الداخلية، والخارجية.. أقول: لست الآن معنياً بعرض شيء من هذا كله. فهو لا يمت إلى الهدف الذي أقمت هذا البحث على محوره بأي سبيل.
وإنما المهم في هذا المقام، أن نتبين المشكلة التي إليها مرد اضطراب الفلاسفة في هذا البحث، والمعضلة التي هي سر عجز المجتمعات الإنسانية عن العثور على أي ثمرة أو حصيلة للكلام الطويل الذي أنشأه، والجدل المتشعب الذي خاضوا غماره، خلال قرون متطاولة امتدت إلى هذا العصر.
والذي يعنيني من إبراز هذه المشكلة، هو أن نعوّد أنفسنا، إذا أقبلنا على دراسة موضوع ما، في فن من الفنون، لا سيّما الفلسفة، أن نحاذر جيداً، من أن نضلّ في شعب الكلام ووراء متاهاته، بحيث ننسى حجم المسألة وإطارها الذاتي، فإن من استدرجتَه تعاريج الجزئيات، حتى خاض في تشقيقات الكلام، واستغرق في متابعة التحليلات المتعارضة، خليق به (في غمرة شتاته الذهني) أن يتوهم الاضطراب الحائر في جنبات البحث تعمقاً منهجياً في لبه وجوهره. فلا يعود من كل ما قرأه وتأمله إلا بالدهشة والانبهار، من جرّاء ذلك التحليل الذي أسلمه إلى أشتات من الفرضيات التي نبهته بدورها إلى أنواع من المشكلات!.. ولعلّ مثل هذا الباحث يمضي وقد اقتنع من الفهم السليم بتلك الدهشة التي بهرته، واطمأن إلى أنه قد وقع على كلام علمي عجيب، لا بدّ أنه الحق الذي يجب المصير إليه، وأنها الحقيقة الراسخة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!..
وإنما العاصم من الوقوع في فلك هذا الاستدراج والضياع ثم الانبهار، أن يبقى الباحث المتأمل متذكراً ومتصوراً حجم المسألة التي يعكف على دراستها، أي حقيقتها الكلية وإطارها الشامل الذي يفصلها عن كل ما قد يلتبس بها. فعندئذ لا يعجز الباحث الواعي عن التنبه إلى الفرق بين طبيعة التحليل العلمي الذي يدنو بصاحبه شيئاً فشيئاً إلى كشف خوافِي المسألة وحل معضلاتها، وطبيعة الحيرة في موضوع مغلق الأطراف، تطوف من حوله –إلى غير ما نهاية – الفروض والاحتمالات
وإذا تبين لنا أن كل ما خلَّفه الجهد الفلسفي، قديماً وحديثاً، من مذاهب وآراء عن حرية الإنسان وما يكتنفها من ملابسات ويقف في طريقها من عقبات، ليس إلا تعبيراً واضحاً عن المشكلة التي استعصت على الحل، وليس بحال من الأحوال كشفاً عن أي خافية فيها ووصولاً إلى أي حقيقة علمية عنها – أقول: إذا تبين لنا ذلك، نكون قد تجاوزنا نصف الطريق إلى بلوغ الحل الصحيح لهذه المعضلة، لأن معرفة المشكلة (أي إدراك أنها مشكلة) تساوي كما يقولون اجتياز نصف الطريق إلى حلها.
ويحين لنا عندئذٍ أن نصغي إلى الحل الذي تقدم إلينا به الإسلام، ذلك الحل الذي يشعر به المسلم الذي وعى إسلامه، في سلوكه وممارسته العملية للحياة، ولكن قلّما يلتفت إليه أولئك الذين يأملون أن يصلوا إلى الحل العلمي والواقعي، من خلال الإصغاء إلى آراء الفلاسفة وعلماء النفس والأخلاق.
***
ونبدأ الآن فنسأل:
أين تكمن المشكلة التي أعجزت الفلاسفة أن يتفقوا على مذهب في تفسير حقيقة الحرية، وفي توضيح سبيلها العملي أمام الناس؟
تكمن هذه المشكلة فيما يلي: على الرغم من أن جميع الفلاسفة اتفقوا على أن الرغبة في (اللا قيد) حيال اختيارات الإنسان، بصدد سلوكه الظاهري ونشاطاته الفكرية والباطنية، شعور أصيل في كيانه ومطلب أساسي في حياته، فإنهم رأوا أن هذا الشعور يتصادم هو وعدة حقائق ثابتة، لا مفرّ من الاعتراف بها ولا جدوى من إنكارها، ثم إنهم لم يهتدوا إلى سبيل سليم لإقامة توازن متكافئ بين هذا الشعور الأصيل الذي لا ينكر، وتلك الحقائق التي لا مفرّ منها.
فهو يتصادم أولاً هو وما يسمونه بالضرورة أو الحتمية، سواء ما كان منها داخلياً يشعر به الإنسان في أعماق كيانه، وما كان منها خارجياً يتمثل في قوانين الطبيعة وأحكامها الثابتة الصارمة.
وهو يتصادم ثانياً مع القيم، على اختلاف الناس في فهم جوهرها وموازينها، فإن مصدرها – مهما اختلفت وتطورت – ثابت لا يتبدل، ألا وهو الوضع الاجتماعي الذي لا بد أن ينضوي تحته الإنسان.
وهو يتصادم ثالثاً مع أنظمة الحكم وسياسة الدولة، أيَّاً كان شكل هذا الحكم، وأيَّاً كان المذهب السياسي المتبع، إذ هي لا يمكن أن تنهض إلا على نوع من الضبط والتقييد.
فهذه المقابلات المتعارضة المتقاومة، هي لبُّ المشكلة التي وقف عندها الفلاسفة قديماً وحديثاً. ثم لم يجدوا سبيلاً إلى حلها أو اجتيازها. وما تدور بحوثهم ومسائلهم عند الحديث عن الحرية إلا على محور هذه المشكلة، وما تفرّقوا أوزاعاً وتشتتوا بين الفرضيات والآراء المتنافرة في شأنها، إلا أملاً في العثور على حل يكمن هنا أو هناك.
قد يقول بعض الدارسين، أن السعي إلى فهم معنى "الحرية" بحد ذاتها، يصطدم بمشكلة أسبق ومعضلة أكبر. إذ ضلّت تحليلات الفلاسفة بين احتمالات كثيرة شتى للمعنى المراد بالحرية.. ترى المقصود بها حرية التنفيذ الفعلي، أي دون قسر من أي قوة باطنية كالأهواء والعواطف.. ثم هل المقصود بها ما يأتي من التصرفات والأفعال بسائق الإرادة المطلقة، أم بما هو أخص من ذلك، وهو عامل المحبة والرضا؟.. وهل ينبغي أن تكمن خلف سلطان الحرية باعث يوجهه ويختار له، أم أن الحرية هي تلك التي تكون طليقة من قيد أي باعث؟ ولا بد أن يقال عندئذ: ولكن فما الفرق إذن، بين الحرية والعبث، وهل بمقدور الإنسان المفكر العاقل أن يتمتع بحرية لا باعث لها؟.. ولقد انتهى بعضهم من ملاحقة هذه التصورات والتأمل إلى الاقتناع بأن الحرية وهم باطل وسراب لا وجود له، من هؤلاء ليبنتس Leibniz وسبنيوزا، وكثير من الفلاسفة الرواقيين.
ولكننا نؤثر أن نسقط هذه المشكلة عن النظر والاعتبار. إذ هي مشكلة نظرية واعتبارية مجردة، لا سلطان لها إلا في نطاق الأخيلة والمحاكمة الفكرية المجردة، أما على صعيد الواقع المحسوس فإنها تنحسر نهائياً.. إذ الحرية شعور ثابت لا مجال للامتراء به، قبل أن يكون فكرة ذات ضوابط وحدود.. وعجز الفكر عن تحديدها لا يلحق أي شك في وجودها.
غير أن المشكلة الحقيقية التي تنعكس على الواقع.. الواقع الفردي والاجتماعي، هي مشكلة البحث في جواب علمي سليم عن السؤال التالي: كيف أُوفق بين حريتي الذاتية، من جهة، وكل من الضرورات القائمة والقيم المرعية والانضباط بأنظمة الدولة ومقتضيات القانون، من جهة أخرى؟.. بل إن جزءاً كبيراً من تلك الحيرة في فهم معنى الحرية وضبطها، ليس إلاَّ واحداً من آثار العجز عن التوفيق بين هذا التعارض الذي ألمحنا إليه.
ولنستعرض الآن موجزاً من مظاهر الاضطراب والحيرة الناتجين عن هذا العجز، لدى الفلاسفة قديماً وحديثاً.
آثرت طائفة كبيرة من الفلاسفة الاهتمام بالشعور الداخلي للإنسان، والذي يلح على إثبات حقيقة أنه مفطور على أن لا ينصاع إلا لرغبته الذاتية وإرادته الطليقة من كل قيد، وأُهملت في سبيل ذلك النظر فيما يسمى بالضرورات القائمة في وجه هذه الرغبة. وأصرّت على أن لا ضرورة في هذه الحياة أسمى من أن يحقق الفرد لنفسه سعادته الشخصية الخاصة به، لا كما يريدها فقط، بل كما يحبها ويهواها أيضاً. وكأن لسان حال هذا الفريق يغري الإنسان أن يبذل قصارى جهده في تحطيم سدود الضرورات التي تقف أمامه بكل ما يمكنه من جهد، ودون النظر إلى الأضرار التي قد تنتج عن ذلك. فإنها –من وجهة نظرهم- مهما كانت أضراراً جسيمة، لن تكون أكثر جسامة من ضرر ذبول الحرية الإنسانية داخل كيان الإنسان. ومن أقدم فلاسفة هذه الطائفة أبيقور (230 ت ق.م) ويؤيده من فلاسفة العصر الحديث الفيلسوف الإنكليزي هوبز (1679 ت).
ولعلنا لا نخطئ إن قلنا أن هذا المذهب يشكّل النواة الخفية الأولى للمذهب الوجودي الذي لا يقيم وزناً لما وراء الوجود الفردي للإنسان، والمتمثل في الذات التي لا تنبثق بتمامها وكمالها إلا من الممارسة الفعلية لكامل حريتها المطلقة.
وآثرت طائفة أخرى المثول بخضوع واستسلام أمام الضرورات الكونية التي تترسخ جذورها في داخل النفس الإنسانية، ثم تنتشر فروعها وأغصانها بمظاهر شتى في المجتمعات الإنسانية على اختلافها. قالوا: فإذا كانت الضرورات الماثلة أمامنا تتصل بجذور راسخة في أعماق نفوسنا، فإن إرادتنا الذاتية ما ينبغي أن تكون متشاكسة مع مقتضيات تلك الجذور الراسخة، ولا يمكن إلا أن تحصر الإرادة نشاطاتها في ظلال تلك الشجرة الثابتة الضاربة بجذورها في أغوار النفس. ومن أقدم من نادى بهذا الرأي الفيلسوف اليوناني سقراط (396 ق.م) وتلميذه الوفيّ أفلاطون (248 ق.م) وثلة من الفلاسفة الرواقيين الذين جاؤوا من بعدهم، وقد بالغ بعض أتباع هذا المذهب، حتى انجرفوا في وهم أن الحرية كلمة لا طائل تحتها ولا مضمون لها، وأن الإنسان مسوق في جميع تصرفاته وأفكاره تحت سلطان أنظمة صارمة لا مفرّ منها. وليس هذا الذي يشعر به الإنسان مما يسمى إرادة أو اختياراً إلا جزءاً من هذا النظام الصارم ذاته، وإنما صاحب الحرية الوحيد في الكون هو الله عز وجل. وقد قلنا إن ممن ذهب إلى هذا الرأي سبينوزا وليبنتس.
ولسنا الآن بصدد البحث في مفهوم الضرورة من حيث أساسها الكليّ عند أصحاب هذا المذهب الثاني، غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن فكرة القضاء والقدر، كان لها تأثير كبير في إعطائهم الضرورة هذه الأهمية الكبرى والسلطان العظيم، وأكثر ما دار من النقاش بين الأبيقوريين والرواقيين حول هذين الرأيين المتعارضين، إنما كان يتمحور حول مسألة القضاء والقدر. غير أننا سنجد عندما نصغي إلى الحل الإسلامي لمشكلة الحرية هذه، أن التصور اليوناني لمسألة القضاء والقدر، تصور خاطئ ينبعث من الوثنية اليونانية ممزوجاً بقدر كبير من الإيمان بالله على طريقة بعض المذاهب الدينية لا سيما بالنسبة لمسألة الخطيئة.
أما فريق ثالث فقد بذلوا جهداً كبيراً لاختيار حل وسط، وعملوا كل ما في وسعهم لإقامة لون مقبول من التناسق والتوفيق بين الحرية الإنسانية والضرورات التي لا مفرّ منها.. واستعانوا لإقناع خصومهم بقدر غير يسير من الكلام الخطابي والتوفيق الخيالي فقالوا مثلاً: إن الضرورة هي المناخ الطبيعي للحرية أي هي الأرضية التي لا يستبين شكل الحرية إلا عليها. وقالوا: إن الحرية لا تكون بدون اختيار، والاختيار لا يتم إلا ضمن حدود الممكنات، ولا تتحدد الممكنات إلا حيث تحيط بها الضرورات، أي الواجبات والمستحيلات.. وقالوا: إن الحرية هي ترويض الإنسان ذاته أن لا يتحرك إلا ضمن دائرة ما تقتضيه السنن الكونية. وذلك عن طريق التجارب المتكررة التي لا بدّ أن تحدد له أخيراً معالم الطريق الذي لا يستقيم السير إلا في داخله.. فالحرية هي المصباح الذي يرى الإنسان على هديه حدود الممكنات ليضبط نفسه بها.
ونحن نقول: إن هذا الكلام مقبول عندما ننطلق من اليقين بأن الإنسان يتمتع بحرية نسبية محدودة. ثم إن هذه النسبية تتسع وتضيق حسب الأحوال والظروف. وعندئذٍ يصبح التوفيق بين الحرية والضرورة سارياً على كل الناس في جميع أحوالهم وتقلباتهم، فحتى السجين أو الأسير بوسعنا أن نقنعه، اعتماداً على هذا المنطق، بأنه حرّ طليق في كيانه، إذ لولا حدود المعسكر أو السجن الذي يطبق عليه، لما تجلى إمكان تنقله بحرية في داخل قاعاته وأروقته وحدائقه.
ولكن إذا أردنا أن نجزم بأن الحرية الإنسانية ثابتة بحد ذاتها، وأن على الإنسان أن يغذيها ويرعاها، وأن على المجتمع أن يقرّ له بذلك، فإن مشكلة ما يسمى بالضرورات والحتميات، لا مناص من الاعتراف بأنها تكذيب صريح لذلك الجزم والادعاء.
ومن أبرز أئمة هذا الاتجاه من الفلاسفة القدامى أرسطو، وكثير من أقطاب الأفلاطونية الحديثة، ومن فلاسفة العصر الحديث بنتام، وستوارت ميل الذي دافع عن الحرية كحقيقة ثابتة متكاملة، بمقدار ما دافع عن الضرورات الاجتماعية كسلطة مهيمنة على الأفراد. ولا ريب أنه غدا أوسع الآراء الثلاثة قبولاً وانتشاراً.
غير أن هذا الاتجاه الثالث زاد المشكلة اتساعاً، وزجّ الناس في مزيد من الضياع!.. فما أن أضفى هذا المذهب على "الضرورة" تلك القدسية التي لا تتكامل قدسية الحرية الإنسانية إلا بها – إذ أقامها مقام الكوابح الطبيعية التي لا بدّ منها ضد عبث الحرية وشذوذها- حتى أسرع كل ذي نزعة سياسية أو اجتماعية أو مادية، يجعل من كلمة "الضرورة" هذه حصناً مقدساً لميوله وأفكاره، ثم أخذ يغزو الحرية وينتقص من أطرافها متخفياً وراء حماية هذا الحصن، مدعياً بأن الحرية لا تستقيم دون خضوع للضرورات. والضرورات هي هذه القيود التي اكتشفها واختارها للناس كي يتقيدوا بها.
فأصحاب النزعة الاستبدادية في أنظمة الحكم والسياسة، يفسرون الضرورات السياسية بمذهبهم الاستبدادي الذي اقتنعوا به.. فما على الناس إلا أن يخضعوا حرياتهم لمقتضياتهم، إذ هي الضرورات التي لا تتحقق كوابح الحرية إلا بها.
وذوو الاتجاهات الديموقراطية (وما أكثرها) يردون على خصومهم بأن الضرورات السياسية ليست كما زعموا، وإنما هي تتمثل في التقيد بأصول النظم الديمقراطية، والخضوع لاستبداد الأكثرية.
أما المنصرفون إلى استخراج أصول كل من الفضيلة والرذيلة وموازينها، فمن المستحيل أن يتفقوا على ميزان لذلك وقد حاول من قبلهم السعي إلى هذا الهدف منذ أقدم العصور فما أرشدتهم عقولهم، ولا أعراف مجتمعاتهم، ولا طبائعهم الإنسانية إلى مقياس متفق عليه يفصل الخير عن الشر ويميز الفضيلة عن الرذيلة، وإنما استقلّ كل فئة، بل ربما كل فرد، بمثله الأعلى الذي يؤمن به، حسب البيئة التي عاش فيها، والتربية التي تلقاها، والظروف التي استحوذت عليه.
وهكذا اختلف علماء الأخلاق اختلافاً كبيراً في فلسفة القيم، ومعرفة الضرورات الأخلاقية، وتفرقوا في مذاهب متباعدة شتى. ثم أخذ كل فريق يجعل من قيمه التي اقتنع أو تأثر بها ضرورة قدسية يجب أن تقيد بها الحرية الإنسانية أيّما تقييد.
ثم أقبل أصحاب المذاهب الاقتصادية وذو النزعات المادية بدورهم، يضعون هم الآخرون دستورهم لقانون الضرورات، ثم يواجهون به الناس، على أنه حقيقة ثابتة حتماً لا تصلح الحرية الإنسانية دون التقيد بها. أي فمقتضيات المادية الجدلية والمادية التاريخية، إن كل ذلك إلا قانون حتمي مبرم. وما الحرية الإنسانية إلا تجربة حركية دائبة، تنبه بشكل علمي إلى مدى ضرورة هذا القانون وحتميته، ومدى استحالة خروج التاريخ الإنساني عليه، في أي من العصور الماضية أو الآتية.
يقول انجلز:
"لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن قوانين الطبيعة، وإنما في معرفة هذه القوانين، وفي الإمكان القائم على هذه المعرفة.. إن الحرية تستقيم في السيطرة على ذواتنا وعلى الطبيعة الخارجية، وهي سيطرة مؤسسة على معرفة الضرورة الطبيعية".
ولا شك أن الضرورة الطبيعية هنا، هي ضرورة نقل وسائل الإنتاج والملكيات العامة إلى أيدي الطبقة الكادحة في ظلّ من دكتاتورية البروليتاريا، المبينة على المادية الجدلية التي هي أم الضرورات الطبيعية والتاريخية كلها في نظر هؤلاء الناس.
وهكذا نرى كيف غدا قانون الضرورة الذي عمدت هذه الطائفة الثالثة من الفلاسفة، فعقدت قرانه على "الحرية" عقداً شرعياً بموجب فتوى صريحة استقلت بإصدارها، أقول: هانحن نرى كيف غدا قانون الضرورة هذا قناعاً يتستر به كل من يريد أن يمضي وقتاً ممتعاً في العبث بالحرية المسكينة على النحو الذي يشتهي ويريد. فما من صاحب بطش وسلطان، وما من متعشق للهو والمجون، وما من صاحب أخيلة وأهواء، إلا وهو يستطيع أن يسمي رغائبه هذه ضرورة طبيعية أو اجتماعية لا مناص منها، ثم يقتحم بها مخدع الحرية الإنسانية ليصفدها من تلك الرغائب بقيود وأغلال، ثم ينطلق وهو يزعم أنه إنما توَّجها بتاج الضرورة الذي كان لا بدّ لها منه.
ولقد أحسّ ستيوارت ميل بمشكلة هذه المذاهب المتضاربة في تفسير الضرورة، ولم يجد في السعي إلى حلها خيراً من أن يفتح باب حرية البحث والنقاش بين هذه المذاهب. فهو يقرر في كتابه "الحرية" أن فتح باب المناقشة وقبول الاعتراض من الآخرين كفيل بأن يكشف شيئاً فشيئاً عن صواب آرائنا إن كانت صائبة، وعن مدى قيمتها. وهو يذهب في تسويغ هذا الاقتراح إلى حيث يقرر أن آراء البشر إنما يحتوي كل منها على جزء من الحقيقة، وإنما السبيل إلى تكامل هذه الأجزاء أن تتلقى وتتمازج بالنقاش الحرّ!.. وحسبنا في التعليق على هذا التصور العجيب، أن نتساءل عن الوقت الذي يحين فيه انبثاق مخيض هذه الآراء المتصارعة عن زبدة الحقيقة الكلية التي تنهي عصر التعارض والشقاق، وقد علمنا أنها ما تزال تتصارع منذ أقدم العصور التي وعاها التاريخ.
ولما قيل لستوارت ميل أن الآداب والمبادئ المسيحية تحوي كل الحقيقة، فلماذا لا نلتقي عليها؟ أجاب معترفاً بأن أكثر ما يعزى اليوم إلى السيد المسيح لم يقله ولم يتحدث عنه، وإن كثيراً مما قاله لم يبلغنا. كما أكد أن ما يسمى بالآداب الكهنوتية ليس مما أخذ عن المسيح ولا مما نقل عن الحواريين، بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على سبيل التدرج أثناء القرون الخمسة الأولى.
وهكذا، فقد كان خير حل لمشكلة "الضرورة" التي تجاذبتها المذاهب والآراء، أن تترك دون حل، وأن ننتظر انبثاق الحل من استمرار صراع هذه المذاهب وتمزّق الشعوب والجماعات الإنسانية فيما بينها.
***
والآني يأتي دور رد الفعل
إن شعور الإنسان برغبته الذاتية في أن يتحرر من قيود الآخرين، وأن يغذي كينونته بحرية السلوك والتصرف والتصور ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، حقيقة ثابتة في كيانه، ما في ذلك شك.
وللنفس دائماً منطقها الذي تنقاد وتثور بموجبه، كما أن للعقل منطقه الذي يتجه ويسير عليه، فلا جرم كان من المتوقع أن يهيج بكثير من الناس هائج النفس والهوى، عندما يرون أن حريتهم غدت ضحية لضرورات المذاهب المتطاحنة والقيم المتصارعة (وما أصحاب تلك المذاهب والقيم إلا أُناس مثلهم) ثم يعلنوا عن استنكارهم لتلك الضرورات كلها، ويثوروا على تلك القيم أنى كانت، ويقرروا من منطلق فلسفيّ أن أقدس ضرورة في دنيا الإنسان وحياته، هي ضرورة احتمائه بحريته الذاتية ضد كل شيء آخر يتربص به. إن حرية الإنسان هي جوهر وجوده، ولا قيمة للوجود الإنساني إلا في مظهره الفردي المتحرر من سجن المجتمع وقيوده، وما حريته إلا اختياره المطلق الذي لا يحده أي دافع أو وازع خارجي!.. ذلك هو ما يسمونه بالمذهب الوجودي، مذهب تقنع بمظهر الفلسفة وألفاظها، وما أخاله ينتمي حتى إلى المصطلحات الأساسية فيها. ولكنه مع ذلك نبت ونما نموه الطبيعي في تربة أغنى وأقوى لها من الفلسفة وأصولها، إنها تربة الهياج النفسي الذي يستند إلى منطقه الواقعي الطبيعي، ألا وهو منطق رد الفعل ورجع الأثر.
ولكن ردود الفعل ما حلّت يوماً مشكلة ولا قوّمت اعوجاجاً. بل الشأن فيها أن تزيد المشكلة تعقيداً. وما المذهب الوجودي في حقيقته إلا مرض نفسي عضال جاءت به مشكلة الجرثومة التي تحدثنا عنها. وهو يمثل الخصام الحاد بين الإنسان الفرد من جانب، وكل من الكون والمجتمع من جانب آخر.
وسلاح الإنسان الوجودي في هذا الخصام إنما هو حريته ضد كل شيء. فإذا كشف له العراك عن عجزه أمام هذا الصراع وأكدّ له أن سلاح حريته لا يغنيه شيئاً أمام قوانين الكون وأحكام المجتمع فليس عليه إلا أن يلجأ إلى ما يسمونه باليأس والقلق والسقوط!. فإن اجتراره لهذه المشاعر الثلاثة خير له من أن يستسلم طواعية لقوانين الكون والمجتمع، ويخضع حريته لسلطانهما. فالإنسان، على حد ما يقوله سارتر، محكوم عليه بالحرية، وإذا كان من مستلزمات خضوعه لها أن يعاني من اليأس والقلق والسقوط، فليكن ذلك!. ويا مرحباً بما تقضي به الحرية!..
وهكذا، فإن الإنسان الوجودي، يسير بخياله إلى حيث يعانق حريته الكاملة، ولكنه بدلاً من أن يلقاها فيعانقها فعلاً، ينتهي إلى سجن اليأس والقلق والسقوط، حيث تأمره فلسفته بأن يلقي عصا التسيار هناك، وأن يقبع في ظلام ذلك السجن آمناً مطمئناً، لأنها الثمرة التي لا بدّ من أن يقطفها ويتناولها عشّاق الحرية!..
***
لقد علمنا الآن أن جميع الاتجاهات والمذاهب الفلسفية القديمة والحديثة، لم تهتد إلى سبيل سائغ لتقويم حقيقة معنى الحرية لدى الإنسان وتنسيق ما بينها وبين ضرورات الكون والمجتمع، بل لم تزد على أن أرهقت الناس بأفكارها المتصارعة تحت وطأة مشكلات مستعصية مغلقة لا سبيل للتخلص منها. فما الحل إذن؟
هاهنا يأتي دور الإسلام، الذي لم يأتِ إلا لينجد الإنسان بحل تلك المعضلات التي لم يستطع أن يستقل بحلها والقضاء عليها.
وقبل أن أتحدث عن الحل الذي يعرضه الإسلام لهذه المشكلة التي نبحث فيها، يجب أن أوضح أن الشرط الأساسي لجدوى هذا الحل وفائدته، إنما يكمن في اليقين الراسخ بأن الإسلام إنما هو آت من عند الله عز وجل. فلا جرم أن من أقبل يصغي إلى تعاليمه وإرشاداته، وهو يتصور أنها مجموعة مواضعات وأفكار بشرية معينة، فإنه لن يجد فيها إلا مذهباً آخر يضاف إلى جملة المذاهب الوضعية في تفسير الحرية الإنسانية وتفسير قيودها وضوابطها. ولن يكون لها من التأثير في نفسه أكثر مما لتلك المذاهب الأخرى، تماماً كالموقف الذي رأيناه لستوارت ميل من المبادئ المسيحية، وهو يجسد في الحقيقة الموقف الأوروبي كله قديماً وحديثاً. وهذا هو السرّ في أننا نرى الحل الإسلامي لهذه المعضلة ماثلاً أمامنا، دون أن نجد أي أثر له، إذ ما جدوى أن يكون الطبيب أمامك، ولكنك لا تظنه إلا واحداً من الفضوليين الجاهلين الذين يجتهدون دون روية ولا علم.
يبدأ الإسلام بحل هذه المعضلة من نقطة أساسية هامة، هي تعريفه الإنسان على ذاته تعريفاً ما هوياً دقيقاً. ولأهمية هذه النقطة تجد خمس آيات القرآن الكريم تقريباً تتضمن تعريف الإنسان على ذاته من حيث المبدأ والمنتهى ومن حيث الصفات التي ركبت فيه والقدرات التي يتمتع بها، ومن حيث الروح التي تسري في كيانه ومآلها بعد مماته.
وقد نبهنا القرآن الكريم بهذا إلى أن معرفة الإنسان ذاته معرفة دقيقة، هي المنطلق الذي لا بدّ منه إلى سائر العلوم والمعارف المختلفة، فإن لم ينطلق إليها من هذا المحور الأساسي، اختلّ سبيل المعرفة واضطرب ميزانها، ذلك لأن معرفة وسائل العلم وأدواته من أبسط المقدمات التي يجب أن يفرغ المتعلم منها أولاً. والإنسان بحد ذاته (من حيث أنه ناطق متأمل) أهم أداة من أدوات المعرفة الإنسانية.
فإذا أصغينا إلى تقرير الإسلام، المتمثل في كتاب الله تعالى أولاً وقبل كل شيء، رأينا وعلمنا أن الإنسان مخلوق من نوع فريد، أبدعه الله عز وجل، وأنه مهما اتجه وتقلّب يدور في قبضته وتحت سلطانه، وأنه يحتاج في كل لحظة إلى استمرار عناية الله به ورعايته له. فوجوده يتحدد في كل لحظة بخلق جديد، وأن كل ما يتمتع به من ملكات وصفات فذّة أمانة استودعت عنده إلى حين. ثم أنه منفعل بهذه الصفات وليس فاعلاً لها. فهو قوي ولكنه لا يدري كيف انسكبت القوة في كيانه، ولا يدري أي سبيل لاستبقائها عندما تبدأ بعد حين بالتراجع والذبول. وهو عاقل يفكّر، ولكنه لم يغرس هذا العقل في رأسه بجهده أو مشيئته، ولا يملك أن يبقيه (إذا هو ارتد غداً إلى أرذل العمر) بجهده ومشيئته. وهو ينطق ولكنه لا يعلم كيف تتم عملية النطق فيما بين حلقه وفمه. وينام دون أن يدري كيف نام ودون أن يعلم شيئاً أكثر من أنه أغمض عينيه منتظراً نعمة الرقاد. ثم يستيقظ ولا يعلم كيف تمت عملية الاستيقاظ. وغداً ينفض يديه من كل هذه الصفات والملكات النادرة، ويرحل من هذه الحياة دون أن يملك حيال ذلك أي تصرف أو إرادة نافذة. وهذا معنى قولنا: الإنسان منفعل بصفات إنسانيته وليس فاعلاً لها.
والسمة الجامعة لكل هذه الظواهر في شخص الإنسان، هي أنه عبد، عبد لمن هو مستقر في قبضته، ولمن يتولى تدبير أمره على النحو الذي يشاء ابتداء ودواماً وانتهاء. وكلمة "العبد" لا تستعمل بين الناس، بعضهم مع بعض، إلا على سبيل المجاز، إذ هي تعني المملوكية التامة، وليس من أحد يتصف بأنه مملوك حقيقة إلا لخالقه الذي هو الله عز وجل. فصفة العبودية إذن، للإنسان، لا تكون حقيقة إلا بالنسبة لله عز وجل وهذا هو قرار الله تعالى في بيانه المعجز: (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم عدّاً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً(.
وعلى هذا، فالإنسان لا يتمتع بأي حرية داخلية، أي متعلقة بجوهر الإنسان، إذ كيف يكون حرّاً وهو عبد..؟ كيف يكون حراً وهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً.
ثم إن الله عز وجل، حتم على الناس جميعاً أن يعرفوا هذه الحقيقة في أنفسهم، وأن يدركوا أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل، ليدركوا ما يعنيه ذلك من ربوبية الله لهم. كما حتم عليهم أن يذعنوا لهذه الحقيقة بعد إدراكهم لها. فقال لهم: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون( بل أمرهم أن يجددوا هذا الإذعان كلما وقفوا بين يديه في صلاة فيقولوا له: (إياك نعبد وإياك نستعين(.
ولكن لماذا حتم عليهم ذلك؟ وماذا يضيره أو يضيرهم أن يكونوا عبيداً له فعلاً دون أن يحملوا أنفسهم على إدراك هذه العبودية والإذعان لها والالتزام بمقتضاها؟ ماذا يضير الحقيقة أو الحياة أن لا يعلموا أنهم عبيد مملوكون لله، فيعيشوا مع خيال أنهم أحرار على أقل تقدير، إن لم يتح لهم أن يعيشوا مع واقعها الحقيقي.
والجواب، أنه عز وجل إنما حتم هذه المعرفة عليهم، بل أمرهم بالإذعان لها، لأن ذلك هو الشرط الوحيد لامتلاك الإنسان له.
فالإسلام يواجه الإنسان بواقع عبوديته الحتمية لله، ليفتح أمامه بذلك آفاق التحرر من آصار العبودية للآخرين من جهة، وليصده عن استعباد المستضعفين من حوله من جهة أخرى. وإذا تأملنا جيداً أدركنا أنه لا ثمن لهذا التحرر، إلا الإذعان الصحيح لتلك العبودية. وقد أبرز القرآن هذا التلازم ببيان صريح، وذلك في قوله عز وجل: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله(.
ومن آثار هذا التلازم، أن تنطوي وتزول مشكلة النقاش والجدل الدائبين حول المذاهب والضرورات التي يتطارحها الناس ليقيد بعضهم بعضاً بها، وذلك نظراً لتساويهم جميعاً في الفكر والنظر، واقتناعهم جميعاً بأن ما يخطه لهم سيدهم ومالكهم من المناهج والسبل هو المذهب السديد الذي لا مناص من اتباعه والحق الذي لا مرية فيه. إذ لا يمكن للإنسان أن يعلم ربوبية الله له من خلال ما علم من عبوديته له، ثم يتهمه – وهو الحكيم الخبير – بجهل في تشريعه أو تحيّز في حكمه، لا.. بل لا بد أن يستقبل أوامره وتوجيهاته بكامل الطمأنينة إليها والقناعة بها، حتى ولو لم يتبين جوانب الحكمة أو الفائدة منها.
والآن، ما هي طبيعة الضرورات التي يقيد بها الإسلام حرية الناس (أعني الحرية الخارجية التي هي الحرية الوحيدة التي يملكونها؟).. وهل هي أقل من الضرورات المذهبية الأخرى تأثيراً في الحرية وانتقاصاً لحجمها؟.
إن بوسع كل من يتأمل في شرائع الإسلام وقيمه الأخلاقية، أن يرى كيف أنها فصَّلت على قدر ما تتطلبه الفطرة الإنسانية السليمة، لإصلاح حال كل من الفرد والمجتمع وإسعادهما، وكيف أنها تنسق بدقة متناهية بين مصلحتي الفرد والمجتمع دون أن يقع أي إجحاف من أحد الطرفين على الآخر. وتفصيل القول في هذا الجانب يتطلب بحثاً مستقلاً، وحسبنا أن نعود إلى دراسة أصول المصالح الشرعية المرسومة في الإسلام، ونتأمل في تناسقها حسب سلم الأولويات الدقيقة الرائعة، ثم نقارن هذه الأصول بالمحاولة الشاقة التي بذلها الفيلسوف البريطاني بنتام في كتابه أصول الشرائع للوصول إلى الهدف ذاته، وكيف أعلن (أثناء محاولته هذه وقبل أن يفرغ منها) أنها محاولة عسيرة مقضي عليها بالخيبة والإخفاق.
ومن أبرز ما تمتاز به شرائعه القانونية وقيمه الأخلاقية، أنها تدور على محور المصالح الإنسانية في كلا شطري حياة الإنسان: معاشه القصير اليوم، ومعاده الطويل غداً. وأوضح أن المرجع في ضبط هذه المصالح وترتيبها إنما هو الديان الحكيم جل جلاله الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى. إذن فلا شأن لتشريعات الإسلام بما يسميه بعض الفلاسفة بالخير المطلق أو الشر المطلق، إذ ليس في موازينه ما يتصف منها بالخير أو الشر الذاتي من حيث الماهية والجوهر. وإنما الخير ما علّق الله به مصالح الناس ومنافعهم الحقيقية، والشر ما علّق به أضدادها أو نقائضها. بمعنى أنه هو الذي خلق الشيء أولاً، ثم أضفى عليه صفة الخيرية أو الشرية ثانياً. ولولا التركيب الاجتماعي الذي فطر الله الوجود الإنساني عليه، لما رأيت شيئاً يستأهل أن يوصف بأنه حسن أو قبيح. تماماً كالقطعة الصغيرة التي تأخذ مكانها الهام من جهاز ثمين مفيد، قد تساوي تلك القطعة، وهي في مركزها التركيبي من ذلك الجهاز، قدراً كبيراً من المال. ولكنها إن انفصلت عنه، ونظر إليها من حيث وضعها الذاتي المستقل، لا تساوي شيئاً. وهذه الحقيقة الهامة من بعض معاني قوله تعالى: (.. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى(.
على أن ثمّة بعض الفرق بين موازين الشرائع القانونية، والقيم الأخلاقية العامة، في نظام الإسلام وحكمه.
*أما القيم الأخلاقية فتمتاز بأن أحكامها ثابتة مبرمة، لا مجال فيها لأي تبديل أو تحويل، ولا تتأثر بتطور أو اختلاف العادات.
وهذا ليس لأنها ذات قيمة جوهرية بحد ذاتها، ولكن لسببين اثنين:
السبب الأول: أن مصدر الأخلاق هنا، لا يتمثل في أعراف سائدة أو مذاهب متعارضة، حتى تختلف باختلافها، ولكن مصدرها قرار الله وحكمه.. ثم هي في مجموعها تنسيق سلوكي دقيق مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله عباده عليها في كل زمان ومكان.
السبب الثاني: أن الأخلاق في ميزان الإسلام، لا تنقسم (من حيث جزئياتها) إلى أخلاق صالحة وأخرى فاسدة، كما يرى جلّ الفلاسفة وعلماء الأخلاق، ومن ثم فلا يمكن أن يتم بينها أي تحاور أو تبادل بالأماكن حسب الظروف والمصالح المتوقعة.
وبيان ذلك أن الله فطر جميع عباده على ملكات وصفات متعددة شتى، وقد تبدو متعارضة متشاكسة، غير أنها في مجموعها هي المادة الأساسية للأخلاق الفاضلة في ميزان الإسلام وحكمه، بمعنى أن الأخلاق الفاضلة لا تتكون إلا من مجموعات متناسقة منها. وإنما الفرق بين الخلق الفاضل وما يقابله من الخلق الذميم، أن الأول مجموعة طبائع تمازجت باعتدال متوازن، والثاني مجموعة طبائع لم تتمازج بتوازن واعتدال.
لا يوصف جوهر البخل بحد ذاته بأنه ذميم، فلولا قدر من البخل عند الإنسان، لما نهض إلى تجارة ولا سعى في صناعة أو زراعة، أو تربية مال. كما لا يوصف البذل بحد ذاته بأنه محمود أو ذميم، فلولا قدر من العطاء لما استقامت العلاقات التعاونية بين الناس على نهج سديد. وإنما ينبثق الخلق الفاضل من تلاقي هاتين الصفتين على صراط الاعتدال طبق الميزان الذي رسمه الإسلام، ونقول مثل ذلك في صفتي الجرأة والخوف، والأنانية والتواضع، والعلم والغضب.. وغير ذلك.
وما قد يستعمل في العرف أو اللغة من الألفاظ الدّالة على الأخلاق الحميدة، لا يعني بعضاً من هذه الصفات دون بعض، وإنما يعني مزيجاً متعادلاً من مجموعها. وكذلك ما قد تجده من الألفاظ الدالة على الأخلاق الذميمة، لا يعني أكثر من انحراف هذا المزيج عن خط الاعتدال والتعادل المطلوب في الإسلام. وقد أفاض في بيان هذا الميزان الثابت الدقيق للأخلاق، كثير من علماء المسلمين كالغزالي وفخر الدين الرازي وعلي ابن سينا وغيرهم.
إذن، فحيثما يسود الإسلام عن دراية ووعي، تستقر القيم الأخلاقية على أساس ثابت لا اضطراب فيه مهما اختلفت الأعراف والأعراق وتباعدت الأقطار أو تبدلت الأزمان. وذلك على النقيض مما يعانيه ذوو النزعات الوضعية في تحليل الأخلاق وتقويمها، من دوامة التناقض والاضطراب، مهما اصطنعوا الموازين وتناقش حولها الفلاسفة والكتاب.
*وأما الشرائع القانونية فتدور، بكل جزئياتها المتنوعة، على محور المصلحة الإنسانية المنظور إليها، من خلال ارتباط المعاش الدنيوي اليوم بالمعاد الأخروي غداً. وإنما المقوم لهذه المصلحة هو الله عز وجل.
ثم إنه جل جلاله أبرم طائفة كبيرة من هذه الشرائع، وأقام أحكامها على أساس راسخ لا يقبل تطويراً ولا تبديلاً، وهي التي علم الله تعالى أنها ترتبط بسنن كونية وإنسانية ثابتة لا تتغير. بينما ربط طائفة أخرى منها بعلل وظروف قابلة للتبدل والتحول ما بين عصر وآخر أو بلدة وأخرى. ثم أمر أولي الدراية والعلم أن يسيروا بهذه الطائفة من الأحكام مع عللها التي أنيطت بها أنى اتجهت وسارت، طبق أصول وقواعد اجتهادية ثابتة.
غير أنه جلّ جلاله إنما شرع لعباده هذا الاجتهاد ضمن دائرة من حرية البحث والنظر على أن تكون مقامة على محور الشورى، وذلك كي لا يتسلل إلى المجتمع باسم هذا الاجتهاد أي استغلال أو تعسف أو تلاعب بأصول الشريعة وموازينه الأساسية الثابتة.
وهذه الشريعة، هي التي تكفل (بما تضمنته من أحكام دقيقة شاملة) توفير مناخ التحرر الحقيقي الأصيل في المجتمع الإنساني (ولنلاحظ أننا نقول التحرر ولا نقول الحرية). فالناس في ظل هذا الشرع متساوون في الحقوق والواجبات، لا يعترف لأي طبقة منهم بأي نوع من أنواع الامتيازات المعروفة في النظم والشرائع الوضعية، ولا يملك أي فرد أو طبقة منهم سلطة تقنين ولا تشريع، وإنما هي سلطة حراسة وتنفيذ فقط. ثم أنه لا سبيل، حتى في حالة ممارسة الشورى التي شرعها الله في المسائل الاجتهادية لتسلل أي استبداد، لا استبداد الأكثرية ولا استبداد الأقلية. إذ الشورى ليست أكثر من تعاون في البحث عن شرع الله وحكمه، حسب ما تهدي إليه أصول الشريعة وموازينها. فالمقياس هو رعاية هذه الأصول، لا رعاية رأي أحد فرداً كان أو جماعة. وكل هذه الأحكام مبسوطة في أماكنها مربوطة بأدلتها.
ولكن، لعل فينا من يسأل: وحرية الاعتقاد، ما موقف الإسلام، لا سيّما وهي أساس هام في عرف جل علماء المجتمع والأخلاق اليوم، بل هي المرتكز الأول في بناء التحرر الإنساني؟
والجواب: إن كثيراً من الباحثين الغربيين ركزوا فعلاً في نطاق دفاعهم عن الحرية، على ما يسمونه بحرية الاعتقاد والشعور والميول. ومن أبرز من دافع عنها ستوارت ميل في كتابه الحرية، كما أصبح فيما بعد، شعاراً يردده معظم الكاتبين، لا سيّما أولئك الذين يتسمون بسطحية النظر والفكر، من مسلمين وغير مسلمين.
غير أني أسأل قبل أن أجيب: هل هذا التعبير (حرية الاعتقاد) صحيح علمياً ومنطقياً؟ أي هل يتصور أن يتمتع الإنسان العاقل، أيَّاً كان، بحرية الاعتقاد؟
الاعتقاد فيما نعلم هو اليقين، واليقين نتيجة قسرية لا مناص منها، لما اقتضته مقدمات الفكر والنظر في أمرها. فالتأمل في زوايا المثلث ودرجاتها بموجب أصول البحث والنظر، يكسبك يقيناً حتمياً بأنها تساوي قائمتين. ورؤيتك لوقوع ما هو في يقينك علّة موجبة لأمر ما، تكسبك يقيناً بحدوث معلوله، سواء قلن أنه يقين علمي أو يقين تدريبي. وكذلك الشعور والميول والأذواق.. كلها انفعالات قسرية تأتي نتيجة أسباب داخلية أو خارجية لا شأن لنا بها.
إذا علمنا هذا، نقول: إن الساحة التي تنتشر فيها الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية، هي جملة الأعمال والتصرفات الاختيارية التي تصدر عن الإنسان. أما فيما وراء ذلك فلا يوجد أي حكم تكليفي قط. وهذا من بعض ما يدل عليه قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها( وقوله عليه الصلاة والسلام: [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه">. إذن، فالمشاعر والأذواق والاعتقادات، لا تتعلق بها الأحكام التكليفية قط. أي لا توصف بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة.
وقد يعجب بعض من يسمع هذا الكلام، فيقول: كيف؟.. أتكون العقيدة (وهي منبع الإيمان بالله) طليقة بعيدة عن ساحة التكليف الرباني؟ إذن فما معنى وجوب الإيمان بالله وحرمة الجحود به، وتعرض الجاحدين به للعقاب الشديد في كل زمان ومكان؟
والجواب أن وجوب الإيمان إنما ينصب على المقدمات الاختيارية التي هي التأمل والنظر بفكر متحرر، لا على النتائج الحتمية التي لا قبل للإنسان بجلبها إليه أو ردها عنه. فإذا قلنا: أن الإيمان بالله واجب على كل بالغ راشد، فمعنى ذلك أن من المحتم في حقه أن يستعمل عقله وسائر طاقاته الفكرية للنظر في ذاته والكون الذي من حوله ثم في هذا القرآن الذي أرسل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام.. ولا ريب أن كل من فعل ذلك بموضوعية وفكر متحرر، هدي إلى الحق ورأى الله تعالى ملء هذا الكون بعين بصيرته، فتأتي العقيدة حينئذٍ نتيجة حتمية لمقدمات اختيارية هي متعلق التكليف الرباني.
والعقاب الذي أعده الله للجاحدين والمارقين من عباده، إنما استحقوه بإعراضهم الاختياري لا بعقائدهم الانفعالية. مصداق ذلك قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكِّر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون( أو استحقوه باستكبارهم على الحق الذي استيقنوه سراً ولكنهم أبوا أن يذعنون له جهراً. مصداق ذلك قوله تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً..(.
وعندما لا يتاح للإنسان أن يتأمل في دلائل وجود الله ووحدانيته وفي القرآن وبعثة الرسل والأنبياء، فإن الله يسقط عنه مسؤولية الإيمان والإسلام ولا يحمل جريرة اعتقاداته الباطلة. لأن المقدمات الاختيارية لم يكن له إليها من سبيل ولأن النتائج الاعتقادية انفعالات قسرية لا سلطان له عليها. هذا ما يقرره جماهير علماء المسلمين استناداً إلى نصوص القرآن وصحيح السنة، لم يخالفهم في ذلك إلا المعتزلة.
إذن، فكل هذا الذي يقوله أو يكتبه كثير من الناس اليوم عن حرية الاعتقاد والدعوة إلى احترامها، لغو من الكلام، وباطل لا معنى له.. ولسنا نعلم قط أن في العقلاء من يستطيع حمل عقله على اعتقاد ما يشاء حتى يمارس ما يسمونه حرية الاعتقاد.
نعم، إن الإنسان يملك كما قلنا أن يوجه فكره إلى الشيء بالتأمل والبحث، وأن يصرفه عنه إذا شاء.. غير أن الإسلام حجب عنه هذه الحرية، وأوجب عليه التأمل والتدبر، على أن لا يكون لغير عقله المتحرر أي سلطان عليه. فهو يقول على وجه الحتم والإلزام: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض( ويقول (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل(.
والحكمة من هذا الالتزام الإلهي، كما قد أوضحنا، أن من شأنه تبصير الإنسان بهويته، وحجزه عن استعباد الآخرين واستغلالهم، وفرض آرائه عليهم. وفي ذلك من فائدة تحرير الإنسان من ظلم الإنسان، أضعاف ما قد يجده من ضرر استلاب حريته بصدد أن يفكر أو لا يفكر في أمر ما.
***
إلا أن في الناس من قد يقول: وهل أبقى الإسلام في الإنسان شيئاً من القدرة على أن يتأمل أو لا يتأمل، عندما صفَّده بأغلال القضاء والقدر، ثم زجه في طريق لا قبل له إلا بالمضيّ فيها طبقاً لما رسم له؟
والحقيقة أن هذه الصورة المرسومة في أذهان بعض الناس عن معنى القضاء والقدر، من أخطر الأخطاء الشائعة التي لا تستند إلى أساس من الصحة لا عن طريق صحيح العقل ولا ثابت النقل.
إن كلا من كلمتي القضاء والقدر، لا يعني شيئاً من معاني الجبر والإلزام، كما يتوهم عوام الناس، وإنما هو من مستلزمات صفة العلم المطلق لله عز وجل.
يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم نقلاً عن الخطابي "وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من إكساب العبد، وصدورها عن تقدير منه".
ويقول ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتح المبين بشرح الأربعين "والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم" وهذا ما يقرره سائر علماء العقيدة أيضاً، كسعد الدين التفتازاني في شرحه على العقائد النفسية والعضد الإيجي في المواقف..
وإذا تبين هذا، فإن مما لا يخفى على أحد أن العلم صفة كاشفة للشيء على ما هو عليه، وليست صفة مؤثرة فيه بأي تغيير حتى ينبثق من ذلك الجبر والإلزام.
نعم، لا شك أن جميع أفعالنا وتصرفاتنا، لا تحدث إلا بخلق الله لها، لضرورة أن الله خالق كل شيء. غير أن الله تعالى إنما يخلق في عبده الأفعال التي اتجه إليها عزمه وعوّل عليها قصده، والعزم أو القصد أو الكسب كما يسمه القرآن، إنما هو في معناه الكلي منحة أكرم الله بها الإنسان، فهو بها مختار مريد. وهو مناط الأجر والوزر في حياة الإنسان. أما أفعاله الاختيارية فإنما يخلقها الله تجسيداً وإظهاراً لانبعاثه القلبي وكسبه المستكن في أعماق نفسه، لتكون شاهداً على قصوده الخفية.
وقد يجادل بعض الناس في هذا العزم الاختياري الذي نجده في نفوسنا، قائلاً: إنه أمرٌ وهميّ محض، فالله هو الذي يوجه الإنسان إلى ما يريد له اختياره.. والحقيقة أن هذه مماحكة تكلف أصحابها شططاً، إنها تكليفهم أن يكذبوا إحساسهم وبرهان مشاعرهم التي تفرّق بين حركتين الجبر والاختيار.. ثم إنهم لا يغطون تكذيبهم هذا، بأي برهان علمي بديل، يغني عن الإحساس والشعور. وإنما هو مجرّد احتجاج بما يفهمونه خطأ من قدرة الله، للتمرد به على أوامره وأحكامه.
ويكفينا لقطع دابر هذه المماحكة أن نحيل أصحابها إلى ما يقوله الله عنهم:
(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون".
***
نخلص من كل هذا الذي ذكرناه، إلى أن عملية الاختيار في كيان الإنسان، ليست في جوهرها أكثر من ممارسة إنسانية لإقامة علاقات متناسقة بين حياة الإنسان ومظاهر المكونات المحيطة به. فالاختيار الذي يمارسه أحدنا لا يتحقق إلا من تلاقي طرفين: أحدهما مستقر في أغوار مشاعرنا، ثانيهما مرتبط بقوانين الكون وأنظمته. وليست الحرية في حقيقتها وواقعها – مهما اختلفت الأقاويل حولها – أكثر من أن يمتلك الإنسان فرصة التنسيق بين هذين الطرفين بقرارات من انبعاثه الداخلي الذي يسمى بالرغبة أو الإرادة. وواضح أن الطرف المرتبط بقوانين الكون هو القطب الثابت، على حين لا يشكّل الطرف الآخر إلا الاتجاه المتحرّك نحوه من خلال سبل شتى.
ومن ثم، فلا بدّ، لكي يمارس أحدنا اختياره السليم، من أن يبدأ فيتعرف على حقيقة الكون الذي يعيش فيه، والسبيل الأمثل للاستفادة منه والتعامل معه. وإنما الذي يعرّفه به على خير وجه مبدع الكون، ذاك الذي خلقه ثم بثّ فيه نظمه وقوانينه. فهو وحده الذي يملك أن يدلّ الإنسان على أصول التعامل مع الكون دون أن يصطدم بشيء من تضاريسه.
فمن لم يفعل ذلك، ثم اقتحم الدنيا التي تموج من حوله، متحرراً من سلطان أي باعث، أو معتمداً على ما قد يرشده إليه وهمه المجرد، فما أشبهه بمن اقتحم قمرة طائرة جاثمة على الأرض، ثم تربع على أريكتها، وترك يديه تعبثان بالأزرار والمحركات التي أمامه ومن حوله على غير هدى وتبصير ممن صمم هذا الجهاز، وأبدعه، ثم وضع له قانون تسيير وسبل استخدامه، مكتفياً على مذهبه الشخصي وقناعته الذاتية، زاعماً أنه يمارس بذلك حريته الشخصية التي لا سلطان لأحد من الناس عليها.
إن مما لا يقبل الريب أننا نعيش من هذا الكون العجيب المحيط بنا، فيما يشبه قمرة هذه الطائرة.. لقد وُجدنا في داخلها دون أي إرادة منا ولا اختيار. ولكنا نملك الآن عقولاً ترشدنا إلى أن لهذا الجهاز الكوني مبدعاً وصانعاً، كما نملك أن نصغي جيداً إلى | |
|
المشرف
وسام النجوم الذهبية



عدد المساهمات : 215
نقاط : 6050
تاريخ التسجيل : 26/12/2009
 |  موضوع: رد موضوع: رد  الأربعاء يناير 13, 2010 11:05 pm الأربعاء يناير 13, 2010 11:05 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للأخ اومولود على اثارة هذا الموضوع ،لكن أرجو أن تحدد لنا المصدر الدي اعتمدته ، هل هو كتاب أم موقع أم مقال ؟؟وشكرا | |
|
